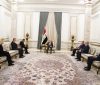غير ان «ادبيات» وأقنية البعثيين تتجاهل هذه الاخبار، وتتمسك بشعار العودة الى حكم العراق، قفزا من فوق السؤال التفصيلي: هل الطريق سالك امام البعثيين لاعادة عقارب الساعة الى الوراء وحكم العراق؟
سؤال أم فرضية؟
انه سؤال تجيزه السياسة، ويقبله علم المصادفة، وتطرحه نظرية الاحتمالات، وتحمله عواصف الاحداث في العراق من بين مفارقات كثيرة، لكنه لا يزيد عن سؤال تنتجه اوهام المهزومين دائما غداة كل تحول في التاريخ، ففي العهد الجمهوري بقي انصار الملكية يثرثرون زمنا طويلا عن حتمية العودة الى «العرش» المفقود، وفي عهد انقلاب شباط كان القاسميون يرون عودة حكم 14 تموز امرا مفروغا منه يوما ما، وبعد انقلاب البكر-صدام على العهد القومي الناصري في 17 تموز 1968 طمأن القوميون الامة انهم عائدون حتما الى حكم العراق، وإن طال الزمن، ومنذ اثنتي عشرة سنة يصدر البعثيون بيانا تلو البيان عن قرب العودة الى القصر الجمهوري، حتى ان فريقا منهم اسس واجهة سياسية باسم حزب العودة، وفي الاونة الاخيرة صاروا يوعدون بتحقيق التعددية السياسية واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة، من دون ان يترافق ذلك مع مراجعة نقدية واضحة لتجربة حكم البعث (الصدامي) في تلك المفاصل ذات العلاقة بنظام اللون السياسي الواحد البغيض ومسخ القضاء واحتكار السلطة من قبل الفرد المستبد ومصادرة الحريات تحت طائلة الاعدام والحكم بواسطة العائلة والحلقة الضيقة من الاتباع ومنع الاحزاب والتنكيل حتى الموت، بالمعارضين، فضلا عن سلسلة الحروب الكارثية التي ارتبطت بالعهد البعثي، والتي تسببت بمقتل وتعويق وترميل وإذلال الملايين من العراقيين، وتسببت في النتيجة النهائية، في وقوع العراق تحت احتلال القوات الاجنبية.
المشكلة اذن، هي ان البعث في غالب فصائله، لا يزال اسير ارثه التآمري الانقلابي الدموي، ولم يتخلص من اغواء الدبابة ووهم السيطرة على الحكم بالقوة المسلحة والسيطرة على الاذاعة واعلان البيان رقم واحد، وتعليق جثث المعارضين على اعمدة الكهرباء، واعادة انتاج كذبة «ثورة 17 تموز» التي لم تكن غير عملية انقلاب جنرالات طامحين بالحكم سرعان ما سقطوا في فخ البعث.
باختصار شديد، ان البعثيين لم يعيدوا النظر في ما الحقوه بالعراق وشعبه من كوارث وإذلال.. وهذا يجيب عن السؤال عما اذا يمكن للبعثيين (المنمطين) ان يعودوا الى حكم العراق.. ومن اي زاغور يمكن ان يتسرب مثل هذا المستحيل.
قبل هذا علينا ان نعرف بان البرنامج السياسي للبعثيين(في جميع تسمياتهم) يقوم على ركنين اساسيين، الاول، رفض التغيير الذي اطاح بحكم صدام وحمل السلاح ضده، والثاني، تبشيع مرحلة التغيير والتأسي على احوال المواطنين الصعبة واستثمار اجواء العنف وتراجع الخدمات واستفحال الفتن الطائفية.
وتحاول نشريات وكتابات البعثيين ان تبرئ النظام السابق وقيادة صدام حسين من المسؤولية المباشرة عما حل بالعراق كنتيجة لاشعاله ثلاثة حروب اضرمت اجواء التوتر وسباق التسلح في المنطقة وانتهت الى مجابهة مع العالم كله وبررت للولايات المتحدة وحلفائها ان تجتاح العراق وتسقط النظام في حرب خاطفة، وقف الشعب حيالها(والجيش النظامي ايضا) متفرجا، مغلوبا على امره، في افضل توصيف موضوعي، ولا زلنا نستعيد وقائع الاستسلام المذل لكبار اركان النظام والقبض على الاخرين وهروب الكثيرين ناجين بجلودهم ومخازيهم.
ويشاء البعثيون وهم يتحدثون عن تردي الاوضاع الامنية والمعيشية و”الوطنية” في العراق بعد التاسع من نيسان 2003 ان يتجاهلوا السؤال المهم: كيف كان العراق قبل يوم من سقوط النظام؟ ففي الثامن من نيسان من ذلك العام كان ما يزيد على ستة عشر مليوناً من العراقيين يعيشون تحت نقطة الصفر من الفقر، فيما هجر مئات الالوف من الموظفين اعمالهم تحت طائلة العوز والفاقة إذ لا تسد مرتباتهم معيشة اسبوع واحد لاسرهم، وبلغت جموع الهاربين، من الشباب بخاصة، الملايين خشية استخدامهم حشوات في ذخيرة حرب جديدة قد تشتعل في اي وقت، في وقت كان صدام قد ادمن اشعال الحروب، وكانت الشوارع تمتلئ بالعاطلين من مسرحي الجيش، وكان الاحتجاج على هذه الاوضاع المزرية مهما كان سلميا وعابرا يودي بصاحبه الى التهلكة وفي الغالب الى الموت، وفي غضون ذلك كانت الصحافة وأقنية التعبير عن الرأي اسيرة وظيفة واحدة هي تزوير الصورة الكارثية للبلاد والتسبيح والتطبيل لالهة الموت والكوارث.
اما الحديث عن السيادة والوحدة الوطنية الذي يدخله البعثيون في حشوة دعايتهم فانه ينبغي ان نتأمل شكل تلك السيادة التي كانت قائمة في عراق الثامن من نيسان 2003 ففي تقويم العالم ووثائق ومحاضر الامم المتحدة حقائق عن ثلث البلاد كانت خارج قبضة النظام الى كيان كردي شبه مستقل، وثلثها الاخر موصد امام النشاط الجوي والعسكري الدفاعي للحكومة الموكول لها حماية السيادة الوطنية، فضلا عن محميات متبرع بها للجيش التركي بحدود عشرة كيلومترات على طول الحدود مع تركيا، وفضلا عن اكثر من عشرين قراراً لمجلس الامن جعلت من السيادة الوطنية (وعائدات العراق وموارده)خرقة مسح حائلة، واخيرا هل نحتاج الى التذكير كيف كان خبراء وضباط غربيون يفتشون في غرف منام صدام حسين وقصوره عن اسلحة محرمة وكان يذعن لها صاغرا في كل مرة؟.
باختصار شديد، يحتاج البعثيون من ورثة حزب صدام حسين الى ان يتذكروا ان الجيل العراقي الذي عاش ايامهم تلك لم يمت بعد، وهذا ليس من بلاغة السياسة فانهم لم يتخلوا عن الشغل بالشعارات القومية المستهلكة ونفخها على الدوام، على الرغم من انهم عطروها بغيرة على العراق ولم يظهروا، بالرغم من كل ما حدث، أي ميل الى معاينة ظلال ومكان هذه الشعارات في الواقع الجديد في ظل التحولات العاصفة التي شهدها العراق والعالم، ولا يزالون يخشون من التحرك خارج بصمات وشخصية وافكار وسياسات صدام حسين.
والآن، اصبح-كما يبدو- من المستحيل تطوير وترشيد حركة البعث الصدامي الى فضاء العمل السلمي طالما رهن نفسه(الى الابد) في مقولات وفتاوى “المُلهم” فضلا عن استحالة انتاج ملهم آخر تمنحه الحياة فرصا اسطورية (مُنحت لقلائل في التاريخ) مثل الفرص التي سنحت لصدام حسين، واستحالة صنع عراق على صورة عراق نهاية ستينيات القرن الماضي، واستحالة تلفيق طبقة جنرالات متنفذين قلبوا الوضع وسلموه لقمة سائغة بيد حفنة حزبية اتقنت لعبة التآمر والتصفيات السياسية.
يقول كثيرون، ومنهم بعثيون عقائديون، ان حزب (او احزاب) صدام حسين كف ان يكون على صلة بافكار ومنطلقات حزب البعث التاريخية التي ارساها المؤسسون الاوائل، وإذ لا تشكل هذه الملاحظة ادانة دامغة لسيرة البعث الصدامي باعتبار ان للحياة فروضا ومشيئات واملاءات اخرى، لكن الشكوى تتمثل(عدا عن الانقلاب العقائدي) في التنكيل، وإسكات الصوت، بجيل الرواد البعثيين (وكذلك الشركاء من طلائع الحزب العراقي) على يد صدام حسين كونهم خرجوا على حدود العقيدة التي صارت تشكل نفسها من عجينة “القائد الضرورة” وجملة من الرطانات التي اسست لصعوده السريع.
ويبدو ان ورثة حزب صدام لا يجرؤون على تقليب تلك الصفحات خوفا من ان تفاجئهم الاسئلة التفصيلية، ومن جهة اخرى لم يعودوا يمتلكون سلطة صدام القاهرة لكي يمنعوا بالقمع اثارة الاسئلة
الجديدة.